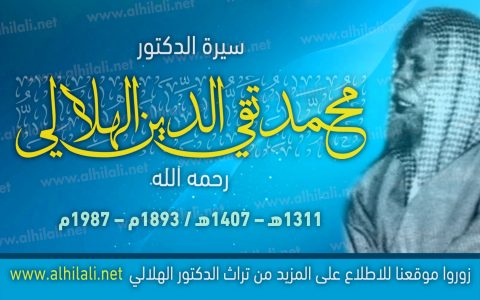تقويم اللسانين مستقيم
وقد عدلت في تعديلك عن العدالة
(2)
5- قال المعترض الفاضل والناقد العادل: وقال (وعمت الفوضى في الإنشاء العربي) فما هذه الفوضى؟ ومن استعملها هذا الاستعمال من فصحاء الأمة العربية؟ إنها من استعمال جهلة المترجمين الذين عاب عليهم الدكتور استعمالهم كلمات عربية في غير مواضعها، إنها ترجمة كلمة (Anarchie).
قال الأب بلو (Belot) في ترجمتها: عدم الحكم في الشعب، أمر فوضى. فالرجل على كونه غير عربي، استعمل الفوضى، صفة لا اسما كما استعملها الدكتور، فالفوضى صفة كالشتى، فالصواب، وعمت الحال الفوضى، وكأني بالدكتور يقول قد حذفنا الموصوف واتخذنا الصفة اسما، فنقول له، ليست هذه بقاعدة مطردة وأنت تدعو إلى اتباع كلام الفصحاء وأقوالهم، وهذا ليس بذاك ولا هناك، ثم ليس هذا موضع التدقيق والتحقيق، فنقول: إن الفوضى أصلها (الفضى) كشتى جمع شتيت، وهي مشتقة من الفعل (فضه يفضه فضا) أي فرقة تفريقا ثم أبدلت إحدى الضادين واوا، والتفرقة هي المعنى المراد بالفوضى، فالفوضى جمع كالشتى، تستعمل للجمع أو لما يمكن أن يتجزأ، وإن كان فكيف يجوز استعمالها اسما جامدا مع لزوم الوصفية الجمعية لها، اهـ.
قال محمد تقي الدين: أيها المعترض الكريم، متى اصطفاك فصحاء الأمة العربية نقيبا لهم، وفوضوا إليك أمر النقض والإبرام في الفصيح من لغتهم وغير الفصيح؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا، وطرت في غير مطارك، وأخاف عليك السقوط، إن ميزان الفصاحة ليس هو فهمك ولا ذوقك، وإنما هو قواعد وضعها الأئمة يرجع إليها ويعتمد في النقد عليها، وسأضع نقدك في الميزان، ليرى القراء، أيثقل، فتكون من المفلحين، أم يخف، فتكون من الخاسرين.
وسنرى هل استعمالي لهذه الكلمة من استعمال جهلة المترجمين، أم نقدك أنت ينتمي إلى جهلة المنتقدين، أنا لم آخذ هذه الكلمة من معاجم آبائك الأجانب، لا من معجم بلو ولا من معجم غيره، وإنما أخذتها من كلام العرب الأقحاح، ومعاذ الله أن أكون في لغة قومي عالة على الأجانب، فاسمع ما يقوله أئمة اللغة العربية. قال ابن منظور في لسان العرب في مادة ف وض ما نصه، وقوم فوضى، مختلطون، وقيل هم الذين لا أمير لهم ولا من يجمعهم، قال الأفوه الأودي:
لا يصلح القوم فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
وصار الناس فوضى، أي متفرقين، وهو جماعة الفائض، ولا يفرد كما يفرد الواحد من المتفرقين، والوحش فوضى، متفرقة تتردد، اهـ. ومثله في القاموس للفيروزأبادي في مادة: ف و ض، ثم قرأت مادة: ف ض ض، في القاموس فلم أجد فيها أثرا لما زعمه المعترض من أن أصل الفوضى، فضى، كشتى وشتيت، ولم يذكر للفوضى مفردا ومقتضى كلامه أن يكون فضيضا، وذلك ضل بتضلال.
فالفوضى من مادة: ف و ض، ومفردها (فائض) كما تقدم من كلام لسان العرب، ومن المعلوم أن الهمزة في فائض منقلبة عن واو.
قوله: كأني بالدكتور يقول.قد حذفنا الموصوف واتخذنا الصفة اسما. الخ، هذا كلام رجل لم يدرس علم النحو فهو يخبط خبط عشواء، أو كلما حذفنا الموصوف وجب علينا أن نتخذ الصفة اسما؟ من قال هذا من أئمة النحو؟ فهل درست ألفية ابن مالك أو ما يساويها من كتب النحو؟ الظاهر أنك لم تدرس شيئا من ذلك، فكيف تتصدر وتنصب نفسك حكما وإماما في علوم الأدب، وأنت لا تعرف ما في الألفية، يقول ابن مالك:
وما من المنعوت، والنعت عقل
يجوز حذفه، وفي النعت يقل
قال ابن عقيل في شرحه: وهو أسهل شروح الألفية في شرح البيت السابق، يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل، نحو قوله تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ أي دروعا سابغات، وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل، لكنه قليل، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ أي البين، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي الناجين، انتهى.
وقال الأشموني في شرحه لألفية ابن مالك، الشرح ممزوج بالمتن ما نصه: (وما من المنعوت والنعت عقل) أي علم (يجوز حذفه) ويكثر ذلك في المنعوت وفي (النعت يقل) فالأول شرطه، أما كون النعت صالحا لمباشرة العامل نحو ﴿أن اعمل سابغات﴾ أي دروعا سابغات، أو كون المنعوت بعض اسم مخفوض بمن أو في، كقولهم: منا ظعن ومنا أقام، أي منا فريق ظعن ومنا فريق أقام، وقوله:
لو قلت ما في قومها لم تيثم
يفضلها في حسب ومسيم
أصله لو قلت: ما في قومها أحد يفضلها لم تأثم، فحذف الموصوف وهو أحد، وكسر حرف المضارعة من تأثم، وأبدل الهمزة ياء، وقدم جواب لو فاصلا بين الخبر المتقدم، وهو الجار والمجرور والمبتدأ المؤخر وهو أحد المحذوف، فإن لم يصلح ولم يكن المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن أو في، امتنع ذلك، أي إقامة الجملة وشبهها مقامه الأصلي إلا في الضرورة كقوله:
لكم قبضة من بين أثرى وأقترا
ترمي بكفي كان من أرمى البشر
وقوله:
كأنك من جمال بني أقيش
يقعقع بين رجليه بشن
انتهى.
فظهر مما نقلته من كلام النحويين أنه يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه بكثرة، بشرط أن تصلح الصفة التي حذف موصوفها لمباشرة العامل، بأن لا تكون جملة ولا شبه جملة، مع كون الموصوف فاعلا أو مفعولا أو مجرورا أو مبتدأ، لأن الجملة لا تصلح لذلك، قاله الخضري في حاشيته على ابن عقيل.
وهذا الشرط ينطبق أتم الانطباق على عبارتي التي انتقدها المعترض جهلا وتهورا، فإننا نقول عمت الفوضى، أي الأحوال الفوضى، لا الحال كما قدره المعترض، لأن الحال مفرد والفوضى صفة للجمع كما تقدم في كلام لسان العرب، وهو كقوله تعالى في سورة سبأ: (10-11) ﴿وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ يخبر الله تعالى أنه ألان الحديد، أي جعله لينا لداود قائلا له، اعمل دروعا واسعات ففي كلامه حذفت الأحوال وهي(فاعل) وأقيمت صفتها مقامها، وفي كلام العلي العظيم: حذفت (دروعا) وهي مفعول به، وأقيمت سابغات مقامها، وحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه يقال فيه، حدث عن البحر ولا حرج يستعمله الناس كل يوم في كتاباتهم وكلامهم بالعربية الفصحى وبالعامية، ولا يكاد أحد يستغنى عن استعماله، قال الله تعالى في سورة المائدة: (38) ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ أي الرجل السارق والمرأة السارقة.
وقال تعالى في أول سورة النور: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ أي الرجل الزاني لا ينكح إلا امرأة زانية، أو امرأة مشركة، وقال تعالى في سورة البقرة: (280) ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ أي إن وجد شخص مدين ذو عسرة لا يجد ما يؤدي به دينه، فلا تضيقوا عليه وأمهلوه إلى أن يتيسر له قضاؤه.
فكيف يزعم هذا المعترض المتخبط أن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ليس من كلام الفصحاء، يا هادي الطريق ضللت:
يا أيها الرجل المعلم غيره
هلا لنفسك كان ذا التعليم
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى
كيما يصح به وأنت سقيم
أما إذا كانت الصفة جملة أو شبه جملة، فيشترط لحذف الموصوف بها أن يكون بعض اسم مجرور (بمن أو في) مثال المجرور بمن، قول العرب منا ظعن ومنا أقام، أي منا فريق ظعن، أي سافر، ومنا فريق أقام، ففريق الذي هو موصوف محذوف وهو بعض ما يدل عليه الضمير (نا) المجرور بمن، ومثال المجرور (بفي) قولهم، فينا سلم، وفينا هلك أي فينا فريق سلم وفريق هلك، وفيما سوى ذلك لا يجوز الحذف، قوله (لو قلت ما في قومها) البيت، قاله أبو الأسود الحماني يصف المرأة بالحسب والجمال. والموصوف المحذوف هنا تقديره (أحد) أي لو قلت أيها المعجب بها بجمالها وكمالها، ما في قومها أحد من النساء في الحسب، وهو مفاخر الآباء والميسم، بكسر الميم، وهو الجمال لم تأثم، لأنك صادق في قولك، والمحذوف هنا وهو (أحد) بعض اسم مجرور بـ(في).
قوله (لكم قبصة) البيت، وصدره، لكم مسجدا الله المزوران والحصى والحصى: العدد الكثير، وقِبصة بكسر القاف أيضا العدد الكثير من الناس، والشاهد في قوله من بين أثرى، والتقدير من بين رجل أثري، أي كثر ماله، ورجل أقتر أي قل ماله، فحذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه، مع أن الموصوف ليس بعض اسم مجرور بمن أو في لضرورة الشعر.
أقول: إن كانت القصيدة التي مدح بها الكميت بني أمية كلها مثل هذا البيت، ولم يعاتبوه عليها، فإنهم كانوا حلماء.
لأن البيت ركيك.
وقوله (ترمى بكفى) البيت، التقدير، ترمى بكفى رجل كان من أرمى البشر، فحذف الموصوف وهو (رجل) وأقام الصفة مقامه، وهي جملة كان، وإنما فعل ذلك للضرورة كالذي قبله.
قوله (كأنك من جمال بني أقيش) البيت، بنو أقيش بصيغة التصغير حي من العرب، وزعم بعضهم أنهم حي من الجن، وإبلهم وحشية شديدة النفور، وزعموا أنها كانت هي أيضا من الجن، والشن القربة اليابسة، ويقعقع يصوت، وجمال هذه القبيلة تنفر بدون سبب، فكيف إذا صوت مصوت بين أرجلها بضربه قربة يابسة، وأراد الشاعر ذم المهجو ووصفه بسرعة الغضب. والشاهد في حذف الموصوف للضرورة، والتقدير كأنك جمل من جمال بني أقيش، فإن قلت، وما الذي يضطرنا إلى تقدير هذا الموصوف، مع أن الكلام يتم بدونه، أقول، لو لم نقدره لم يكن في البيت ما يعود عليه ضمير رجليه، ولا بد له من شيء يعود عليه أيها المعترض الكريم. أظنك أدركت زمان الإمام العلامة السيد محمود شكري الآلوسي، رحمه الله، ولم تكن من تلاميذه، بل حرمت الاستفادة من بحر علمه الغزير، ولم يصحبك التوفيق الذي صحب تلامذته، كالأستاذ محمد بهجة الأثري، وشاعر العرب معروف الرصافي وغيرهما، ولو أنك كنت من تلامذته لم تهد إلينا هذا الهذيان، متوهما أنه جواهر البيان.
وقول المعترض: إن الفوضى، أصلها الفضى، كشتى جمع شتيت، وهي مشتقة من الفعل (فضه يفضه فضا) أي فرقه تفريقا، ثم أبدلت إحدى الضادين واوا، والتفرقة هي المعنى المراد بالفوضى فالفوضى جمع كالشتى، الخ.
إن كان جمعا فما هو مفرده؟ على مقتضى زعمك يكون مفرده فضيضا، فإن كنت ناقلا فعليك بتصحيح النقل، فإني لم أجد في كتب اللغة أحدا أشار إلى شيء مما ذكرت، وقد تقدم أنه من مادة (ف و ض) وإن كنت مخترعا لهذا الاشتقاق الفاسد، وظننت أنك تستطيع أن تروجه على قراء دعوة الحق أجمعين، فقد بلغ بك الغرور كل مبلغ.
واعلم أيها القارئ العزيز، أنني لم أستفد لفظ الفوضى من كلام المترجمين الجاهلين أو العالمين كما هو شأن المعترض الذي اتخذ القسيس (انسطاس الكرملي) إماما معصوما في علوم اللغة العربية، ولم يأت علومها من أبوابها كما فعل غيره من أدباء العراق النبلاء، فكأن الشاعر عناه بقوله:
إذا ما أتيت الأمر من غير بابه
ضللت، وإن تدخل من الباب تهتد
وإنما أخذت ذلك اللفظ من شعر الأفوه الأودي أنشده بعض المؤلفين في علم العروض فقال:
لا يصلح الناس فوضى لا سُراة لهم
والبيت لا يبتني إلا بأعمدة
فإن تجمع أوتاد وأعمدة
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
ولا عمود إذا لم ترس أوتاد
وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا
وليت شعري، ما معنى قوله: ثم ليس هذا موضع التدقيق والتحقيق؟ ما المراد بهذا أهو لفظ الفوضى؟، أم حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها؟ وأيهما قصده لم يكن لكلامه معنى.
وقوله: فالفوضى، جمع كالشتى، تستعمل للجمع، أو لما يمكن أن يتجزأ، الخ أما كونها صفة جمع، فمسلم، ولكن إذا عرف ذلك، فكيف قدر موصوفها مفردا في تصحيحه الفاسد؟ بقوله فالصواب: وعمت الحال الفوضى؟
يصيب وما يدري ويخطي وما درى
وكيف يكون النوك إلا كذلك
ثم إن ادعاءه أن هذا اللفظ يكون صفة للجمع، أو لما يمكن أن يتجزأ، وإن كان مفردا، من أين علم أنه يكون صفة لما يمكن أن يتجزأ وإن كان مفردا، وما هو هذا الشيء الذي يتجزأ وهو مفرد، أهو جنة تتجزأ إلى أشجار؟ فنقول شجرة من جنة، أم روضة تتجزأ إلى أزهار؟ فنقول: زهرة من روضة، أم ماذا؟، وهل هذا الادعاء نقل أو اختراع؟ فإن كان نقلا فليصححه بأن ينسبه إلى قائله من الأئمة، وإن كان اختراعا فهو من تخيلاته الفاسدة ونيات غيره، فلا يساوي قلامة ظفر عند المحققين.
ثم أقول له، والحال التي قدرتها محذوفة وجعلت الفوضى صفة لها والأمر الذي نقلته من كلام أبيك (بلو) الفرنسي وأعجبت به كل الإعجاب، هل هما من المفرد الذي يتجزأ؟ فكيف تجزئهما؟ أثلاثا أم أرباعا أم أخماسا، أو أجزاء لا يعرف عددها؟ هل فكرت في هذا الأمر قبل أن تكتبه وترسله من بغداد إلى الرباط هدية ثمينة إلى أدباء المغرب وأدباء العالم؟ ما أخال أن أدباء العراق يرضون بخطتك هذه، ويعتبرونها شيئا مشرفا، وقد يعتبرونك كبراقش التي كانت تجني على أهلها، ونحن ننزه أدباء العراق المحققين عن مثل هذه السفاسف المرتجلة.
ثم إن تمثيل الإمام ابن عقيل لحذف النعت أي الصفة بقوله تعالى في سورة البقرة: (71) ﴿قَالُوا۟ ٱلۡـَٔـٰنَ جِئۡتَ بِٱلۡحَقِّ﴾ أي البين، فحذفت الصفة وهي البين، تمثيل غير صحيح، لأن موسى قال لهم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُوا۟ بَقَرَةࣰۖ قَالُوۤا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوࣰاۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡجَـٰهِلِینَ﴾ فلم يكن بنو إسرائيل يعتقدون أن موسى أجابهم في أول الأمر بالحق المبهم، وفي آخر الأمر بالحق البين، بل ظنوا أنه يتخذهم هزؤا، وفهم موسى ذلك من كلامهم، فاستعاذ بالله منه، وعده من الجهل وهو السفه.
وكذلك تمثيله بقوله تعالى في سورة هود (46) ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي الناجين، لا حاجة إلى تقدير هذا النعت، لأن نوحا عليه السلام حين قال: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ لم يرد بذلك أن يخبر أن الابن الهالك من ذريته، وإنما أراد أن يقول، إنه من أهله الذين يستحقون الرحمة والعفو لقربه من رسول الله نوح أحد أولي العزم، فأخبره الله أن ذلك الابن ليس من المؤمنين بما جاء به أبوه، فلا يستحق النجاة ولا الرحمة بالقرابة المجردة، فإنها لا قيمة لها عند الله، قال تعالى في سورة الطور: (21) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾.
وقال تعالى في سورة الأنعام بعد ذكر الرسل: (87-88) ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فمن أشرك من ذرية الرسل حبط عمله واستحق الخلود في العذاب، ولم تغن عنه قرابته من الرسول شيئا، والصواب ما مثَّل به الأشموني حيث قال والثاني كقوله تعالى: (18-79) ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ أي كل سفينة صالحة، وقوله:
فلـم أعـط شيئا ولـم أمنع
أي شيئا طائلا وقوله:
ورب أسيلة الخدين بكر
مهفهفة لها فرع وجيد
أي فرع فاحم، وجيد طويل.
6- قال المعترض: وقال (ربما استعمله بعض كبار الأساتذة الذين يرجى منهم المحافظة على صحة الاستعمال، أراد بالبعض هنا غير واحد منهم، مع أن (بعض) لم تكرر في الجملة حتى تدل على غير الواحد فالمكررة كالقول الذي قاله الدكتور في نقده هذا (تحدث بعضهم إلى بعض) وكما في الآية الكريمة التي اتخذها شاهدا وهي (فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) فإذا لم تكرر، وكان المضاف إليه الذي أضيفت ذا أجزاء منفصلة) أو ممكن فصلها دلت على واحد أو واحدة.
أقول في جوابه بالعامية العراقية (ياباه شاباش) وبالعامية المصرية (عفارم) ما هذا العلم الغزير، والتحقيق البديع؟ والآن أضع في الميزان هذا النقد، ليعرف القراء الأعزاء قيمته.
ادعى المعترض أن لفظ (بعض) إذا كرر دل على أكثر من واحد، وإذا لم يكرر، وكان المضاف إليه ذا أجزاء منفصلة، أو ممكن فصلها دل على واحد أو واحدة، أقول من وضع هذه القاعدة؟ إن كنت ناقلاً، فلم لم تَعْزُ ما نقلت إلى قائله وتذكر فيه الخلاف أو الإجماع إن كنت من المحققين كما تزعم، وإن كنت مخترعا، ما أنت علي، ولا أبو الأسود، ولا الخليل ولا سيبويه، ولا من هو دونهم من النحاة واللغويين، فما تضعه من القواعد هوس لا قيمة له، وما أحسن ما قال بعضهم في أمثالك:
تصدر للتدريس كل مهوس
فحق لأهل العلم أن يتمثلوا
لقد هزلت حتى بدا من هزالها
سفيه يسمى بالفقيه المدرس
ببيت قديم شاع في كل مجلس
كلاها وحتى سامها كل مفلس
اسمع ما يقوله الأئمة في (بعض) قال ابن منظور في لسان العرب (بعض) الشيء، طائفة منه، والجمع أبعاض، قال ابن سيدة، حكاه ابن جني، فلا أدري أهو تسمح أم هو شيء رواه، واستعمل الزجاجي (بعضا) بالألف واللام فقال: وإنما قلنا البعض والكل مجازا، وعلى استعمال الجماعة له مسامحة، وهو في الحقيقة غير جائز، يعني أن هذا الاسم لا ينفصل عن الإضافة، قال أبو حاتم: قلت للأصمعي، رأيت في كتاب ابن المقفع: العلم كثير، ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل، فأنكره أشد الإنكار وقال الألف واللام لا يدخلان في (بعض وكل).
ومضى إلى أن قال وقوله تعالى: ﴿يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ بالتأنيث في قراءة من قرأ به، فإنه أنث، لأن بعض السيارة سيارة، كقولهم: ذهبت بعض أصابعه، لأن بعض الأصابع يكون اصبعا وأصبعين وأصابع، اهـ.
تأمل قول ابن منظور في بيان قول العرب، ذهبت بعض أصابعه لأن بعض الأصابع، يكون أصبعا وأصبعين وأصابع، وكذلك (بعض الأساتذة) يكون أستاذا وأستاذين وأساتذة ولا فرق، فبطل بذلك ما زعمه المعترض من أن (بعضا) إذا لم يكرر يدل على واحد أو واحدة فقط.
قوله: وشاهدنا كتاب الله العزيز ففيه: ﴿يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ الخ أقول: نعم الشاهد كتاب الله. ولا حجة لك فيه، لأن لفظ (بعض) مذكر ومفرد، والضمير يعود عليه مفردا حسب لفظه، فليس فيه دليل على ما زعمت، لأننا نقول كما قال ابن منظور: إن (بعضا) إذا أضيف إلى جمع يدل على واحد أو اثنين أو أكثر، فنحن لا ننكر أنه يدل على واحد في بعض الأحيان، ولكننا ننكر ما ادعيت من أنه لا يدل إلا على واحد أو واحدة بالشرط الذي ذكرته من مخترعاتك.
وقوله: ولولا أنزل على بعض الأعجمين فقرأه، أيها المعترض المسكين لقد استهدفت ونصبت نفسك للرماح دريته، نحن نعلم أن الله حرمك من حفظ القرآن ولكنه لم يحرمك من مصحف يوجد في خزانة كتبك فهلا راجعته قبل أن تحرف كتاب الله وتغيره، ففي أي سورة وجدت هذا اللفظ؟ وفي أي آية؟ لقد خانتك ذاكرتك الواهمة وأظنك تريد قوله تعالى في سورة الشعراء (198-199) ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ وغاية ما في الآيتين أن (بعض) هنا تدل على واحد، وأنا لا أنكره، ولا حجة لك فيه، وكذلك يقال في آية التحريم وأما قول الشاعر:
ولانت تفرى ما خلقت
وبعض القوم يخلق ثم لايفرى
فلا أسلم أن (بعض) هنا تدل على واحد فقط، والقرينة والواقع يحتمان أنه يدل على أكثر من واحد، أما الواقع، فإن الذين يرسمون الخطط لعمل من الأعمال، ويعزمون على تنفيذها فريقان فريق ذوو عزائم ماضية وهمم عالية، ينفذون كل ما رسموا له خطة، وفريق ذوو عزائم واهية، وهمم سافلة، يقولون ما لا يفعلون ويعزمون على مالا ينفذون، ولا يمكن أن ينحصروا في واحد.
وأما القرينة، فإن الشاعر يريد أن ممدوحه من ذوي الهمم العالية الذين إذا قالوا فعلوا، وإذا وعدوا أنجزوا، وكثير من الناس تقصر هممهم عن التخلق بهذا الخلق، وعلى تأويل المعترض، يكون الناس كلهم ينجزون وعودهم ويوفون بعهودهم، وينفذون ما رسموا من الخطط إلا واحدا، فلا يكون فيه مدح، وقد ظهر أن هذا البيت حجة عليه ولا له.
وأما بيت أبي دلامة وبيت بشار، فمع تسليمي لدلالة (بعض) فيهما على واحد أقول: لا حجة في كلام أحد من المولدين، وبشار بن برد كان مجوسيا عجميا، كان يزمزم على الطعام قبل أن يظهر إسلامه، ومع ذلك هو من فحول الشعراء المحدثين، ولا حجة في كلامه.
أما قول لبيد: أو يعتلق بعض النفوس حمامها.
فقد اختلفوا في دلالة (بعض) هنا، والصحيح أنها تدل على واحد، ولا حجة للمعترض فيه، لأن الخلاف بيني وبينه ليس في صحة دلالتها على واحد، وقال تعالى في سورة الزخرف: (63) ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾.
قال الراغب في غريب القرآن: قال أبو عبيدة: ﴿وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ أي كل الذي كقول الشاعر:
أو يرتبـط بعض النفوس حمامهـــا
وفي قوله هذا قصور نظر منه، وذلك أن الأشياء على أربعة أضرب: ضرب في بيانه مفسدة، فلا يجوز لصاحب الشريعة أن يبينه، كوقت القيامة، ووقت الموت، وضرب معقول، يمكن للناس إدراكه من غير نبي كمعرفة الله ومعرفته في خلق السموات والأرض، فلا يلزم صاحب الشرع أن يبينه. ألا ترى أنه كيف أحال معرفته على العقول في نحو قوله: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وبقوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ وغير ذلك من الآيات وضرب يجب عليه بيانه كأصول الشرعيات المختصة بشرعه، وضرب يمكن الوقوف عليه بما بينه صاحب الشرع كفروع الأحكام.
وإذا اختلف الناس في أمر غير الذي يختص بالنبي بيانه فهو مخير بين أن يبين وبين أن لا يبين حسبما يقتضي اجتهاده وحكمته، فإذن قوله تعالى: ﴿وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ لم يرد به كل ذلك، وهذا ظاهر لمن ألقى العصبية عن نفسه، اهـ. قال محمد تقي الدين: قول الراغب (ضرب في بيانه مفسدة) الخ خطأه لأن صاحب الشريعة لا يعرف وقت القيامة لقوله تعالى في سورة الأعراف: (187) ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ وقوله سبحانه في سورة لقمان: (34) ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾.
وقوله (وضرب معقول، يمكن للناس إدراكه) الخ، جرى في ذلك على مذهبه الاعتزالي أن العقل وحده كاف لمعرفة الله، والحق أن العقل وحده لا يكفى في ذلك، فلا بد من بيان الرسل، وسائر كلامه لا إشكال فيه.
وعلى ما زعمه المعترض يكون معنى قوله تعالى: ﴿وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ ولأبين لكم مسألة واحدة من الذي تختلفون فيه، وكفى بقول يفضي إلى هذا فسادا، ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة آل عمران: (50) ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ قال القنوجي في: فتح البيان، عن الربيع قال: كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى، وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى، لحوم الإبل والثروب، فأحلها لهم على لسان عيسى وحرم عليهم الشحوم فأحلت لهم فيما جاء به عيسى، وفي أشياء من السمك وفي أشياء من الصيد، وفي أشياء أخر حرمها عليهم، وشدد عليهم فيها، فجاءهم عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل، اهـ.
فعلى قول المعترض لا يمكن أن يحل عيسى لبني إسرائيل إلا شيئا واحدا، وقد أحل لهم أشياء عديدة كما رأيت أيها القارئ الكريم، وهذه نصوص القرآن التي زعم أنها تنصره، فإذا بها تخذله لأنه ليس من أهل القرآن، لا حفظا ولا عملا وإيمانا، فإن القرآن يقول في سورة البقرة: (185) ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ، وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وهو يأكل ويشرب في رمضان جهارا على أعين الناس، وهو شاهد غير مسافر، والقرآن يقول في غير ما آية: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وهو لا يقيم الصلاة، ولا يؤتي الزكاة ويحتج علي بنصوص الفقه في مسألة لغوية لا علاقة لها بالفقه. والمبتدئون من تلاميذ الأدب، فكيف بالعلماء يعلمون أن أقوال الفقهاء ليست حجة في اللغة، وهل سمعتم بفقيه لا يصلي ولا يصوم، ورأسه منذ عشرين سنة أبيض كالثغامة، يسوء الغانيات إذا رأينه؟
هذا آخر هذا المقال وموعدنا الجزء التالي بحول الله وقوته.
مجلة دعوة الحق: العددان 101-102 (العددان 9و10 – السنة 10) – ربيع2 جمادى1 1387هـ – يوليوز- غشت 1967م – ص: 26-31
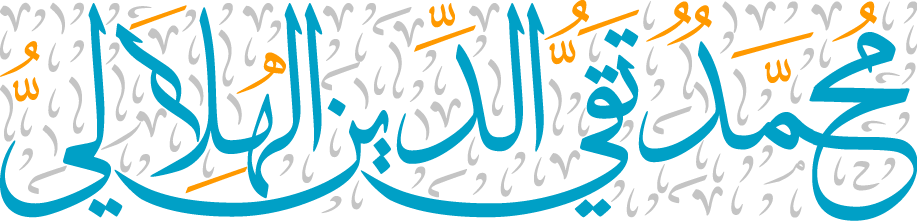
![تقويم اللسانين [تعقيبات..] (3م2)](http://www.alhilali.net/wp-content/uploads/taqwim-lisanayn-03-2-1080x675.jpg)