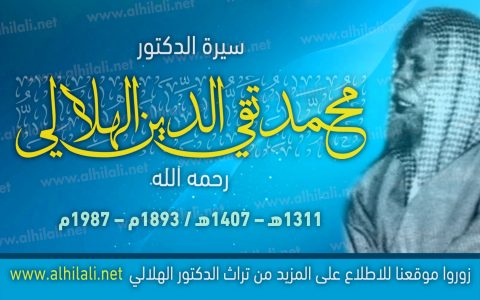[رد على مقال ينتقد ما كتبه الدكتور الهلالي في الحلقات السابقة]
تقويم اللسانين مستقيم
وقد عدلت في تعديلك عن العدالة
من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: (آمنت بالله، واعتصمت بحول الله، وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أُظلم أو أَجهل أو يُجهل علي).
بهذا الدعاء أفتتح الرد على هذا المنتقد الذي حاد عن منهج النقد المستقيم، وتنكر وتنقب، كأنه يعلم أنه مليم، وقبل ذلك أشكر الأستاذ الأديب رئيس تحرير دعوة الحق على الكلمات التي أثنى بها على مقالات تقويم اللسانين.
ثم أعيد ذكر ما قدمته في فاتحة هذه المقالات ونصه، وقد بدا لي أن أكتب مقالات في هذا الموضوع، أداء لواجب لغة الضاد، وصونا لجمالها من الفساد راجيا أن ينفع الله بما أكتبه تلامذتي في الشرق والمغرب وفي أوربا، وأنا على يقين أنهم يتلقون ما أكتبه بشوق وارتياح، وكذلك رفقائي الكتّاب المحافظون سيستحسنون ذلك.
أما الكتّاب الذي يكرهون التحقيق، ويرخون العنان لأقلامهم بدون تبصر ولا تمييز، بين غث وسمين، وكدر ومَعين، فإنهم سيستثقلون هذا الانتقاد، وقد يعدونه تكلفا وتنطعا، وتقييدا للحرية، بزعمهم، فلهؤلاء أقول: إني لم أكتب لكم فما عليكم إلا أن تمروا على ما أكتب مرور الكرام وتدعوه لغيركم الذين يقدرونه حق قدره اهـ.
فكأن هذا الرجل رأى نفسه من الكتّاب الذين يرخون العنان لأقلامهم ويكرهون التحقيق فأخذه المقيم المقعد، وفقد رشده، فأخذ يلتمس العيوب للبراء.
فإن يخلق لي الأعداء عيبا
فقول العائبين هو المعيب
وما أبرىء نفسي من الخطأ، فالكمال لله، والعصمة للأنبياء ولا أكره الانتقاد المستقيم الذي يريد به صاحبه الإصلاح والبناء، ويشهد الله أني ما تصديت لكتابة هذه المقالات إلا أداء للواجب، ونصحا للأمة، وغيرة على لغة القرآن التي هجمت عليها لغات المستعمرين في عقر دارها، فأتت بنيانها من القواعد، وهدمت أركانها، وذهبت ببهائها وجمالها ولم أشك أن دعاة الإصلاح يرحبون بهذا المجهود ويؤازرونه، كما أنني أعلم أن دعاة الهدم والفوضى، أكررها مرة أخرى على رغم أنف المتنطع، سيشرقون بهذا الإصلاح ويغصون به ولكن:
إذا رضيت عني كرام عشيرتي
فلا زال غضبانا علي لئامها
ودونكم أيها القراء الأعزاء ما كتب به إلى الأستاذ المؤلف ذائع الصيت أبو الحسن علي الحسني الندوي من لكناؤ في الهند في الترحيب بهذه المقالات قال حفظه الله، استفدنا كثيرا من مقالكم القيم في العدد الأخير من مجلة دعوة الحق، في موضوع عثرات الأقلام، وغلطات اللسان، في كتابات المعاصرين، وأرجوا أن تتفسحوا في هذا الموضوع، فكلنا في حاجة إلى مثل هذه التوجيهات التي تصدر من ضليع محقق مثلكم، أبقاكم الله طويلا لتلاميذكم الكثيرين في الشرق والغرب.
تلميذكم الصغير أبو الحسن علي بن العلامة السيد عبدالحنى رح الحسني رح – 2- 2-1387هـ.
أما هنا في المغرب فقد رحب بها غير واحد من القراء مكاتبة ومشافهة، ولا يظنن هذا المنتقد أن الجو خلاَ لَه، حتى يبيض ويصفر وينقر ما شاء أن ينقر، فإن بين قراء هذه المجلة العالمية فحولا لا يقعقع لهم بالشنان ولا يخدعون بالمغالطات والروغان، يزنون الأقوال بالقسطاس المستقيم، ويميزون بين الصحيح والسقيم، وسيحكمون بيني وبين هذا المعترض الذي نصب نفسه حكما، وتوهم أن حكمه لا ينتقض.
وقبل أن أخوض معه غمار المعركة مستعينا عليه بالله الذي يحق الحق ويبطل الباطل، أذكر للقراء الأعزاء بعض ما أعرفه من أخباره، وأترك سائرها إلى أن يحين أوانه، كان هذا الرجل يدرس في فرنسا وكان مبتلي بهذا التنطع من أول أمره، فوجه انتقادا إلى أمير البيان الزعيم العربي الأوحد الذي:
حلف الزمان ليأتين بمثله
حنثت يمينك يا زمان فكفر
إلا وهو الأمير شكيب أرسلان رحمه الله، وكنت أنا إذ ذاك أدرس في جرمانية، وأحاضر اللغة العربية بجامعة (بُنْ) فكتب إلى الأمير شكيب المسائل التي انتقدها عليه المعترض والتمس مني الحكم، فنظرت فيها فوجدت الحق في أكثرها مع الأمير شكيب، ووجدت اعتراض المعترض ساقطا إلا في النادر.
وابن اللبون إذا ما لز في قرن
لم يستطع صولة البزل القناعيس
ولكن الأمير شكيب رحمه الله، كان عنده من الإنصاف والتواضع ومكارم الأخلاق، ما يندر وجوده في هذا الزمان فلذلك لم يرد أن يجيبه حتى يعلم رأيي فيما انتقده عليه، ثم عرفت المعترض بعد ذلك معرفة تامة، وكان يجمعنا بيت واحد، نشتغل فيه جميعا، وهو من الكتّاب المشهورين في النثر، وله نظم لا يبلغ حد الجودة، ولكن لا بأس به.
وقد طرق هذا الباب الذي طرقته أنا اليوم من قبل في الصحف العراقية وفي الإذاعة ولم ينجح فيه، بل كان عامة القراء يستهزئون به، ولم أتعرض قط، إلى نقده، مع أني وجدت في ما كتبه ثغرات وأخطاء لأني أعلم أنه من الأساتذة القليلين الذين يكتبون إنشاء حسنا ويتكلمون كلاما قليل الخطأ، فغض الطرف عن هفوات هؤلاء عندي هو الصواب، والسعي في هدم ما بنوه من الفساد.
وأنا لا أطمع أن يكون له من أصالة الرأي وسداده ما يحمله على أن يعاملني بمثل ما عاملته به، لأن طبعه لا يسمح له بذلك، وحسبي أن يكون انتقاده معتدلا خاليا من الجور وأمارات سوء القصد، ولكن الأمر كما قيل: وكل إناء بالذي فيه يرشح.
1- (بدون) قال المعترض: قال في مقالته (ويرخون العنان لأقلامهم بدون تبصر ولا تمييز، ثم قال: وإنما سميت زائدة، لأن الكلام يتم بدونها) فأنا أقول له، من استعمل كلمة (دون) من فصحاء الأمة العربية هذا الاستعمال؟ ولهذا المعنى؟ إن معنى بدونها، هو بأقل منها.
المجيب: يالله للعجب، من جهل هذا المعترض بقواعد النقد! كيف يحتج بكلام المؤلفين من الفقهاء، كأن كلامهم قرآن، أو حديث نبوي، أو شعر امرئ القيس أو النابغة الذبياني، ومن قال لك: إن كلام الفقهاء حجة في اللغة العربية؟ يرجع إليه ويعتمد في الحكم عليه؟ كان يجب عليك قبل أن تتصدى للاعتراض أن تعلم أن الحجة إنما هي في ما صح عن العرب في جاهليتهم، وفي دولة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ودولة بني أمية قبل أن يختلط العرب بالأعاجم، وتفسد ألسنتهم، أما كلام المولدين، ولو كانوا من فحول الأدباء والشعراء كابن الرومي والبحتري والمتنبي، بل بشار بن برد أيضا لا يحتج بشعره مع قربه من العصر الأموي، فهذه حجتك التي جئت تصول بها؟
قال الراغب: في غريب القرآن: يقال للقاصر عن الشيء (دون) قال بعضهم هو مقلوب من الدنو والأدون الدنيء، وقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: 118] أي ممن لم يبلغ منزلته منزلتكم في الديانة، وقيل في القرابة، وقوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ [النساء: 48] أي ما كان أقل من ذلك، وقيل ما سوى ذلك، والمعنيان يتلازمان وقوله تعالى: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: 116] أي غير الله وقيل معناه، إلهين متوصلا بهما إلى الله اهـ. فانظر إلى قول الراغب (وقيل ما سوى ذلك) يعني أن بعض اللغويين فسروا (مادون ذلك) بسوى ذلك، ثم قال والمعنيان متلازمان فبأيهما عبرت يفهم المعنى الآخر، ثم انظر إلى قوله فيما حكى الله تعالى عن عيسى بن مريم في آخر سورة المائدة: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي غير الله، فقد استعملت هنا (دون) بمعنى غير، بغير اختلاف، فما هو جواب المعترض؟
وقال صاحب لسان العرب بعد ما ذكر تسعة معان، (الدون) وقال (يعني الفراء) في قوله تعالى:﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ دون الغوص، يريد سوى الغوص من البناء، اهـ – سبأ.
فهذا من استعمال (دون) بمعنى سوى، فماذا يقول المعترض في تفسير الفراء؟، وقال الفيروزابادي في القاموس، (دون) بالضم، نقيض فوق، ويكون ظرفا بمعنى أمام ووراء وفوق ضد، وبمعنى غير، قيل ومنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أي في غير خمس أواق، قيل ومنه الحديث، أجاز الخلع دون عقاص رأسها، أي بما سوى عقاص رأسها، أو معناه بكل شيء حتى عقاص رأسها، اهـ.
أقول فقد رأيت نقل الفيروز أبادي عن أئمة اللغة أن (دون) تستعمل بمعنى (غير) لكن الاحتجاج على ذلك بالحديثين غير صحيح إذ يحتمل (دون) أن يكون في كل منهما بمعنى أقل، ولذلك حكاه بصيغة التمريض، ومعنى الحديث الأول، أن الزكاة لا تجب في أقل من خمس أواق من الفضة، والأوقية أربعون درهما. فالمقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة لا يقل عن مائتي درهم، ومعنى الحديث الثاني، أن المرأة الناشز التي طلبت فراق زوجها كراهية له، يجوز أن تفتدي نفسها بكل ما تملك إلا ضفائر رأسها، هذا معنى الحديث، وقد اختلف الأئمة في هذه المسألة، وليس هذا محل ذكر الخلاف.
وقال صاحب مجمع مجار الأنوار – وفيه (أي في الحديث) الحاكم يحكم بقتل، على من وجب عليه، دون الإمام، أي عنده أو هو بمعنى غير انتهى.
وقال تعالى: في سورة الأنعام (14) ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.
المعنى قل يا محمد، أغير الله أتخذ وليا، أتوجه إليه في جلب الخير ودفع الضر، والله خالق السموات والأرض، وغيره لا يخلق شيئا، بل هو نفسه مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يتخذ وليا، أي إلها، والله يطعم كل طاعم، ولا يحتاج إلى من يطعمه، وكل طاعم، أي آكل محتاج إلى الله، والمحتاج لا يكون إلها.
قل يا محمد لجميع الناس، إن الله أمرني أن أكون أول من أسلم وجهه إليه، ووحده في ربوبيته وعبادته، ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح للخطاب، وقال تعالى في سورة الشورى (6): ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾.
وقال تعالى فيها أيضا:(9): ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وأمثال هاتين الآيتين كثيرة جدا في القرآن.
والمراد بلفظ من (دونه) في آيتي الشورى هو بعينه المراد بغير الله في آية الأنعام فهذا تفسير القرآن بالقرآن، فماذا يقول فيه المعترض؟ وقال تعالى في سورة النجم (57-58) ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ * لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ والآزفة: القيامة.
قال القاسمي في تفسيره: أي ليس لقيامها غير الله مبين لوقته كقوله:﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف: 187] وكاشفة صفة محذوف، أي نفس كاشفة أو حال كاشفة، أو التاء للمبالغة، أو هو مصدر بني على التأنيث، ومن (دون الله) بمعنى غير الله، اهـ.
أقول: ينبغي أن أمسك عِنان القلم بعد ما تبين الحق في هذه المسألة، ورجع المعترض، يجر أذيال الهزيمة، نادما على تفوه ما ليس له به علم. قوله (وهو فقيه، ولعله درس في الفقه زواج المرأة بدون مهرها أي بأقل من مهرها الخ)، أرجو أن أكون كما قال فقيها عند الله، وعند عباده المؤمنين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)، ذكره البخاري تعليقا في كتاب العلم من صحيحه، والعبارة التي ذكرها المعترض، ونسبها إلى كتب الفقه فاسدة، لم أرها في شيء من كتب الفقه التي اطلعت عليها من كتب أهل السنة، فإن كانت موجودة في فقه الشيعة الذين ينسب إليهم المعترض، فليذكر لنا أين وجدها، وعلى فرض وجودها، لا يصح الكلام إلا بتأويل، إذ ليس للمرأة مهر معين عند أهل الحديث، بدليل (التمس ولو خاتما من حديد) وبدليل (أملكناكها بما معك من القرآن) رواه البخاري وغيره، وحده بعض الفقهاء بربع دينار، لكن الفقهاء يقولون إذا لم يسم لها مهرا، أي صداقا، فلها صداق أمثالها، فإن صحت العبارة التي نسب إلى الفقه، كان الكلام على حذف مضاف (أي بدون مهر نظيراتها من النساء).
وأنا لا أنكر أن دون تستعمل بمعنى أقل، بل كلامي لا يأباه، لأن (دون) هو الأقل منها، أي ناقص عنها، ولكن ضلاله كان في حصره معنى (دون) في أقل، وجهله أنها تكون بمعنى (غير) وبقية كلامه ساقط لا يحتاج إلى جواب.
2- واعتراضه على قولي (لعدم وجود أركانه) بقوله، لأن الوجود لا يعدم وإنما يعدم هو الموجود تنطع وتفلسف عقيم.
قال في اللسان والقاموس – وجد من العدم فهو موجود، اهـ وقال الراغب في غريب القرآن: وقال بعضهم الموجودات ثلاثة أضرب، موجود لا مبدأ له ولا منتهى، وليس ذلك إلا الباري تعالى، وموجود له مبدأ ومنتهى، كالناس في النشأة الأخيرة، اهـ.
وقال الراغب أيضا، الوجود أَضْرُب: وجود بإحدى الحواس الخمسة، نحو وجدت زيدا، ووجدت طعمَه، ووجدت صوتَه، ووجدت خشونته، ووجود بقوة الشهوة نحو، وجدت الشبع، ووجود بقوة الغضب، كوجود الحزن والسخط، ووجود بالعقل أو بواسطة العقل، كمعرفة الله تعالى، اهـ. ومن ذلك تعلم أن وجود الشيء في نفسه هو ضد عدمه، ووجود الناس له، هو غير وجوده في نفسه، فإذا نفينا وجوده فقلنا لا وجود له انتفى باللازم وجود الناس له، أي إدراكهم إياه.
وأركان التشبيه في الكاف الاستعمارية لا وجود لها في نفسها، ولا يدركها أحد، فوجود الناس لها معدوم، ولعل المعترض لا يفهم هذا المعنى، وهو متلهف إلى الطعن، فتوهم أنه وجد مطعنا، فارتد طعنه عليه في هذا كما وقع له في الأولى.
فلا تحفرن بئراً تريد بها أخاً
فإنك فيها أنت من دونه تقع
كذاك الذي يبغى على الناس ظالما
تصبه على رغم عواقب ما صنع
قوله (إن الفصحاء لم يستعملوا كلمة (عدم) هذا الاستعمال) الخ، دعوى بلا دليل، ومتى نصبك الفصحاء قاضيا، ووضعوا زمام الفصاحة في يديك؟ ووكلوا أمرها إليك، تثبتها لمن تشاء وتنفيها عمن تشاء، ألا يحق لي أن أتمثل في حكمك هذا بالشطر الأول من قول الشاعر العربي القح:
ما أنت بالحكم الترضى حكومته
وأما الشطر الثاني فاتركه تكرما
3- قال المعترض: وقد خالف الفصاحة العربية باستعماله جمع القلة المنكر (أنفسا) مع أن مقتضى الحال يوجب استعمال (النفوس) أعني جمع الكثرة، فذوو الظلم كثيرون، أو كثير على الأفصح، وإنما قلت المنكر، لأن المعرف (بأل) أو الإضافة من هذا الجمع يجوز أن يستعمل للكثرة، الخ. يا أيها الناس: اقرءوا واسمعوا وتعجبوا من هذا المعترض الذي يصدر الأحكام واحدا بعد واحد بدون دليل ولا برهان، ولا استناد على قاعدة، ولا عزو إلى إمام فكأنه يظن أن القراء أطفال في المدرسة الابتدائية، يتقبلون منه كلما حدثهم به، ودونكم ما قاله الأئمة في جمع القلة وجمع الكثرة، ونيابة أحدهما عن الآخر وضعا أو استعمالا.
قال الأزهري في التصريح ج 2 ص 300، ما نصه: وله رأي لجمع التكسير الذي يتغير فيه بناء مفرده لفظا سبعة وعشرون بناء منها أربعة موضوعة للعدد القليل وهو من الثلاثة إلى العشرة بدخول العشرة على القول بدخول الغاية في المغيا، ولو قال وهو الثلاثة والعشرة، وما بينهما لكان أولى وهي أفعُل، بضم العين، كأكلب، جمع كلب، وأفعال كأجمال بالجيم جمع جمل، وأفعِلة بكسر العين، كأحمرة، جمع حمار، وفِعْلة، بكسر الفاء وسكون العين، كصِبْية جمع صبى، وخصت هذه الأوزان الأربعة بالقلة، لأنها تصغر على لفظها، نحو أكيلب، وأجيمال وأحيمرة، وصبية، بخلاف غيرها من الجموع فإنها ترد إلى واحدها في التصغير، وتصغير الجمع يدل على التقليل، وإليها أشار الناظم بقوله:
أفعلة أفعل ثم فعلة
تمت أفعال جموع قل
وليس من جموع القلة (فُعَل) بضم الفاء وفتح العين، كغرف، ولا (فعل) بكسر الفاء وفتح العين، كنعم، ولا فعلة بكسر الفاء وفتح العين، كقِرَدة خلافا للفراء.
وثلاثة وعشرون موضوعة للعدد الكثير، وهو ما تجاوز العشر، وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بناء الكثرة وضعا أو استعمالا، اتكالا على القرينة، قاله في التسهيل:
قال الشاطبي: وحقيقة الوضع أن تكون العرب لم تضع أحد البناءين استغناء عنه بالآخر، والاستعمال أن تكون وضعتهما معا، ولكنها استغنت في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر اهـ.
فالأول كأرجل، جمع رِجْل بسكون الجيم، وأعناق جمع عُنُق، وأفئدة جمع فؤاد قال الله تعالى:(5، 6) ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (8-12) ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ (14، 43) ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ فاستغنى فيها ببناء القلة عن بناء الكثرة، لأنها لم يستعمل لها بناء كثرة.
والثاني: كأقلام جمع قلم، قال الله تعالى:(31- رقم الآية 27) ﴿مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ﴾ والمقام مقام مبالغة وتكثير قطعا، وقد استعمل فيه وزن القلة، مع أنه سمع له وزن كثرة، وهو قلام، وقد يعكس، فيستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بناء القلة وضعا أو استعمالا اتكالا على القرينة.
فالأول كرجال جمع رجل بضم الجيم، وقلوب جمع قلب، وصردان بكسر الصاد، جمع صُرد، بضمها وفتح الراء، اسما لطائر، تقول: خمسة رجال بخمسة قلوب معهم خمسة صردان، فيستغنى بجمع الكثرة عن جمع القلة لعدم وضعه وليس منه، أي من هذا القسم، وهو ما لم تضع العرب له بناء قلة ما مثل به الناظم وأنبه من قولهم في جمع صفاة، وهي الصخرة الملساء، صفي بضم الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء لقولهم في جمع قلتها، اصفاء حكاه الجوهري وغيره، بل هو من القسم الثاني، وهو ما وضعت العرب له بناء قلة، ولكنها استغنت ببناء الكثرة عنه كقوله تعالى (2- 228) ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ نفسر ثلاثة بجمع الكثرة، مع وجود جمع القلة، كقوله صلى الله عليه وسلم:(دعي الصلاة أيام إقرائك) وعلى ذلك يحمل قول الناظم:
وبعض ذي بكثرة وضعا يفي
كأرجل والعكس جاء كالصفي
انتهى – وقد طالعت ما عندي من شرح الألفية كالأشموني بحاشية الصبان وابن عقيل وبحاشية الخضري وألفية ابن بونا بحاشيته، فوجدتهم لا يختلفون فيما نقلته عن التصريح، واخترت كلامه، لأنه أوسع وأوضح. ومنه تعلم أن ما زعمه المعترض من أن جمع القلة لا يستعمل في موضع جمع الكثرة إلا إذا كان مضافا أو معرفا بالألف واللام، لا وجود له في كلام أولئك الأعلام ومحال أن يهملوه لو كان ثابتا في القواعد الصحيحة المسلمة.
فنحن نطالبه بتصحيح النقل، إن كان ناقلا، وإن لم يكن ناقلا، فقد كذب على النحاة، واخترع قاعدة من عنديته، فإن جاء بالنقل عن بعض علماء اللغة قابلنا نقله بتلك النقول، وهي أكثر فيسقط نقله، أو يكون مرجوحا، ولو ثبتت القاعدة التي ادعاها ما أغنته شيئا، لأن جمع القلة المنكر قد استعمل في موضع جمع الكثرة في أفصح الكلام وأبلغه، وهو كتاب الله، قال تعالى في سورة لقمان: (27) ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ والمقام يقتضي استعمال جمع الكثرة، ومع ذلك عدل عنه إلى التعبير بجمع القلة، اكتفاء بالقرينة، هذا مع أن للقلم جمع كثرة على (قلام).
قال ابن منظور في لسان العرب، القلم: الذي يكتب به، والجمع أقلام وقلام، قال ابن بري: وجمع أقلام أقاليم، وأنشد ابن الأعرابي:
كأنني حين آتيها لتخبرني
وما تبين لي شيئا بتكليم
صحيفة كتبت سرا إلى رجل
لم يدر ما خط فيها بالأقاليم
وقال أيضا في مادة: ط.ل.ح – وطلحة الطلحات، طلحة ابن عبيد الله بن خلف الخزاعي، ثم نقل عن ابن الأعرابي في طلحة هذا أنه، إنما سمي طلحة الطلحات بسبب أمه، وهي صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة، زاد الأزهري، ابن عبد مناف، قال وأخوها أيضا طلحة بن الحارث، فقد تكنفه هؤلاء الطلحات كما ترى، وقبره بسجستان، وفيه قال ابن قيس الرقيات:
رحم الله أعظما دفنوها
بسجستان طلحة الطلحات
قوله (أعظما) دفنوها، يريد عظام طلحة الطلحات المذكور، وهو من استعمال جمع القلة في موضع جمع الكثرة، لأن عظام الجسم كثيرة، وجمع القلة يدل على تسعة أو عشرة، فأين ما زعمه المعترض من أن جمع القلة إذا كان نكرة لا يستعمل في موضع جمع الكثرة.
وقال تعالى في سورة القيامة:(3) ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ فعبر بجمع الكثرة، لأن عظام الإنسان كثيرة، وعبر الشاعر بجمع القلة لوجود القرينة الدالة على أنه يريد الكثرة، فما يقول المعترض في هذه النصوص القاطعة؟ وهذه القواعد المحكمة؟
قوله (وكأنني بالدكتور) وقد قرأ هذا الاعتراض يلجأ إلى ثلاثة قروء. أقول في جوابه، أنا لا ألجأ إلى ثلاثة قروء، وإنما تلجأ إليها النساء وأشباههن من الرجال الذين يقاتلون من وراء جدر، وقد أقمت الدليل على بطلان ما ادعاه دون أن التجئ إلى ما توهمه.
4- قوله: فما معنى القنابل في اللغة العربية؟ أقول في جوابه:
جاء شقيق عارضاً رمحه
إن بني عمك فيهم رماح
ومن قدمته نفسه دون غير
رأى غيره التأخير ذاك التقدما
أتظن أنه لا يعرف معنى القنابل والقنابر في الدنيا أحد غيرك، لقد كذبتك نفسك، أنا ما جاريت جهلة المترجمين، بل أنت جاريتهم، وأجلبت بخيلك العجاف، ورجلك الضعاف، لتصحيح أخطائهم، وتقف في طريق المصلحين الناصحين لقومهم، لتكتسب بذلك شهرة، وما نقلت عن أولئك المؤرخين، ولم تسم أحدا منهم من استعمالهم القنبر والقنابر بالراء – لا يساوي عند علماء اللغة جناح بعوضة، لأنهم ليسوا من العرب، وكلامهم ليس بحجة، فالعرب لم تعرف هذه الأشياء المتفجرة التي تسمى في هذا الزمان (قنابل) وليس من واجباتها أن تضع لها لفظا، بل ذلك من واجباتنا نحن، وأنت تعلم أنه ليس للمتكلمين بالعربية دائرة معارف، أو موسوعة كما يسمونها، متفق عليها تجمع شتات ما نحتاج إليه، إما أن نستعمل اللفظ الذي اصطلح عليه جماهير الكتاب والقراء، ليكون كلامنا مفهوما عند قرائنا، وإما أن يخترع كل واحد منا ما يعجبه من الألفاظ فلا يفهمه أحد سواه، فكأنه يكتب لنفسه، لا لقراء كتابة أو مجلته، ولا شك أن الصواب هو اختيار الطريق الأول.
وما المانع لنا أن نضع لفظ القَنْبَلة بفتح فسكون ففتح، الذي عبرت به العرب عن الطائفة من الناس ومن الخيل لما يسمى بالإنكليزية (Bomb) وبالفرنسية (Bombe) ولاسيما وقد شاع استعمال هذا اللفظ بين المتكلمين بالعربية من عرب وغيرهم، فيكون بالنسبة إلى أهل زماننا يدل على المعنيين كليهما؟ وما الذي يجعل لفظ (القنبر) أولى بالتعبير من القنبلة والقنبل، هل عندك شاهد من القرآن أو من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم على صحة ما زعمت؟ أما القنبر في لغة العرب فدونكم معناه أيها القراء الأعزاء، قال ابن منظور في لسان العرب: والقبر والقبرة، والقنبر والقنبرة والقنبراء: طائر يشبه الحمرة، الجوهري القبرة واحدة القبر، وهو ضرب من الطير قال طرفة وهو يصطاد هذا الطير في صباه:
يالك من قبرة بمعمر
خلا لك الجو فبيضي واصفري
ونقري ما شئت أن تنقري
قد ذهب الصياد عنك فابشري
لا بد من أخذك يوما فاحذري
ومثله باختصار في القاموس وفي حياة الحيوان للدميري ما نصه: القبرة، بضم القاف وتشديد الباء الموحدة، واحدة القبر، قال الجوهري: وقد جاء في الشعر (قنبرة) كما تقوله العامة، وقال البطليوسي في، أدب الكاتب، وقنبرة أيضا بإثبات النون، قال وهي لغة فصيحة، وهو ضرب من الطير يشبه الحمر، وكنية الذكر منه أبو صابر، وأبو الهيثم، والأنثى، أم العلعل، وأنشد أبيات طرفة المتقدمة، اهـ.
فظهر مما تقدم أن استعمال القنبر فيما يسميه الأوربيون (Bomb) ليس من اللغة العربية في قبيل ولا ديبر:
أقول لك أيها المعترض الكريم: إن احتجاجك بكلام غير العرب باطل، فالكلمة التي نبحث فيها لم تسمها العرب، لا قنبرة ولا قنبلة، ولنا أن نصطلح على تسميتها بما نشاء وليس ما يشتهيه بعضنا حجة على غيره، وأنا لا أعيب على المترجمين إلا خطأهم فيما عرفته العرب وتكلمت به، ومنعهم جهلهم من معرفته، فعبروا عنه بعبارات فاسدة، لا مستند لها، أما آلاف المحدثات من الأجرام والأعمال والآلات والمكتشفات فلا أتعرض لها، إذ لا يستطيع أن ينشرها إلا جماعة من العلماء اللغويين تنتخبهم الأمة العربية وتتلقى ما يضعونه من الكلمات بالقبول والاستعمال، ولا يستطيع شخص واحد أن يقوم بهذا العمل، فدع المغالطة واستقم، واقتصر على هذا القدر، وموعدنا الجزء التالي إن شاء الله.
مجلة دعوة الحق: العدد 100 (العدد 8 – السنة 10) – محرم 1387هـ – جوان 1967م – ص: 28-33
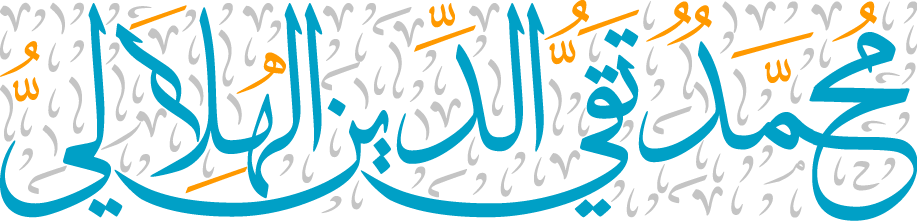
![تقويم اللسانين [تعقيبات..] (3م)](http://www.alhilali.net/wp-content/uploads/taqwim-lisanayn-03-1-1080x675.jpg)